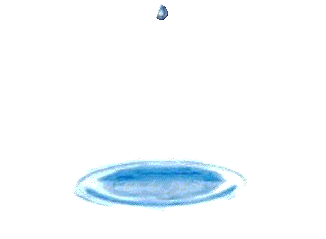
[img][/img]
من السجن الي رحاب المسيح
أنا فرنسي، وأبي كان يدير حانة إلى جانب عمله كبيطار. وكان ولوعاً بالخمر، يعبّ منها كميات كبيرة. ومنذ صغري أخذت عن والدي حب الخمرة. وأذكر أنني في الرابعة من عمري، كنت أتسلق الكرسي لتصل يدي إلى الرفوف التي كانت توضع عليها الكؤوس، لأتناول البقايا التي كان رواد الحانة يتركونها في كؤوسهم. وما أن بلغت الرابعة عشرة حتى كان حب الخمرة قد تأصل فيّ، فكنت أحتسي منها إلى أن يتعتعني السكر.
في يوم من أيام الشتاء. وفيما أنا عائد من الحانة، أتمايل ذات اليمين وذات الشمال، زلت بي القدم فسقطت أرضاً وشج رأسي ولم أستطع النهوض، حتى جاء عابر سبيل وأقامني.
لقد صار لي شرب الخمرة مرضاً، غير قابل للشفاء. وحين كانت النقود تنقصني، كنت أسرق من المحل الذي أعمل فيه عدداً من زجاجات «الديبونه» وأفرغها في جوفي في غفلة عن صاحب المحل.
في الثامنة عشرة من عمري، التحقت بالبحارة بموجب عقد لثلاث سنوات. وهناك كنت أشرب باستمرار، مما حمل ربان الباخرة على طردي من عملي. ولكن الطرد لم يحملني على التوقف عن الشرب.
كسكير ابتلعت الكأس سجاياه الخلقية، أضفت إلى ولوعي بحب الخمرة سيئات كثيرة وخطايا فظيعة بمقدار أني أُحلت على القضاء وحكم عليّ بالسجن لمدة سنة ونصف، لأجل ارتكابي جريمة سرقة.
حين أُفرج عني وفيما أنا أتسكع أمام إحدى الحانات، أُصبت بإغماء مفاجئ حتى ظنت صاحبة الحانة أنني فارقت الحياة. ولكن بعد أن قدمت لي بعض الإسعافات عدت إلى وعيي.
في الخامسة والعشرين، كانت حالي قد تفاقمت جداً. فقد تلاشى من نفسي الشقية كل شعور بالسرور. وهربت الابتسامة من وجهي، وحل مكانها عبوس بشع. كنت أعيش حياة خالية من كل ما يسمى نظاماً أو قاعدة. فولعي بالخمرة، صار نوعاً من الجنون، فأقصتني الحال التي صرت إليها عن الإنسانية وَنُبذت من المجتمع كما تُنبذ النفايات.
ولكن فيما أنا نزيل سجن «ريون» جاء المسيح يفتش علي. كنت يومئذ في حالة بؤس شديد. لأن المواد الغذائية كانت شبه مفقودة في تلك السنة 1941. لذلك كنا نعاني من صيام قسري. بيد أن هذا الصوم الذي لم أسع إليه، صار بالنسبة لي أمراً حسناً. لأن بعض الشياطين، قال يسوع، لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. والواقع أنني في تلك البرهة كنت أطالع كتاب الله المقدس. والكتاب المسمى بأسبوع المسيحي، وأتعمق في محتويات التاريخ المقدس باللغة الألمانية.
وفي هذه الكتب الثلاثة وجدت الزاد الروحي لنفسي، التي كانت في مسيس الحاجة إليه. وقد حصلت على هذه الكتب عن طريق المقايضة بعلبة سجائر لكل كتاب. ويمكنني أن أصف الصفقة هكذا: أعطيت أشياء تخص الشيطان، مقابل أشياء تخص الله... وهكذا فإن تلاوة كلمة الله والصلاة عملتا مع محبة المسيح في حياتي لإنهاضي من سقوطي شيئاً فشيئاً إلى أن صرت في المسيح خليقة جديدة.
إلا أن أمر إيماني وتجديد حياتي لم يمر بسهولة. فقد نعتني بعض السجناء بالمؤمن الزائف، الذي يمثل مسرحية لكي ينال عطفاً، وبالتالي يُطلق سراحه. ولكن الله في المسيح باركني ورسم لي الطريق الواجب أن أسلكها.
في يوم بهيِّ الجمال من عام 1945 نُقلنا إلى سجن «نيمس» المركزي. وهناك كان علي أن أكافح بجد وسرعة لأجل إطلاقي. ومع أنني قدمت كل الوثائق اللازمة لأجل تحرري من السجن، وبالرغم من أن مدة سجني كانت قد انتهت منذ سبع سنوات، فقد رُفض طلبي وهذا الرفض أتاح لإبليس أن يهاجمني، هامساً في أذني، أين هو إلهك؟ أين قوته؟ أين حبه؟ والذي ضغط على نفسي بالأكثر هو أن عدداً عديداً من رفاقي السجناء، الذين لم يتقوا الله ولا اتكلوا عليه حصلوا على الحرية، مع أنهم لم يقضوا سوى برهة وجيزة في السجن!
أمام هذه الحادثة المرة بدأت أفقد شجاعتي، وإبليس عدو الخير والصلاح بدأ يحرضني على ترك الصلاة.
وبعد فترة من الزمن نُقلت إلى سجن سان مارتان دي ري وهناك أيضاً جاهدت بشدة لأجل إطلاق سراحي. وذات يوم وضعت أمام الامتحان. فقد كان كثيرون من السجناء يُرسلون للعمل في الخارج ولكن واحداً فقط كان يخرج حراً على دراجة مع نقود، لشراء حاجات السجن . ولسبب ما، لا أعرف كيف أشرحه، أُعفي الشخص المعين من مهمته وطُلب إليّ أن أذهب بديلاً عنه. وهكذا صرت أتجول في شارع سان مارتان دي ري وأتنقل بين المحلات التجارية ومخازن التموين لشراء المؤن للسجن، ثم أعود إلى السجن جزلاً سعيداً.
وأخيراً حل يوم أراد فيه ضابط جيش الخلاص أن يهتم بأمري. فأوصى بي مدير مصح «فاليون» لكي يطلب إطلاقي للعمل في المصح. وبعد مساع قُبلت الوساطة، وأُفرج عني في أول كانون الثاني 1949. وفي ذلك التاريح كنت قد أمضيت أحد عشر عاماً في السجن مع أن العقوبة التي حُكم علي بها كانت ستة أشهر فقط.
في فاليون كان عليَّ أن أدخل بيئة جديدة بالنسبة لي. كان ذلك وسط العمال، مع العلم أنه لم يسبق لي أن مارست عملاً جدياً، إذا استثنيت الأعمال القليلة التي مارستها في صغري، أو في السجن. كنت في حاجة إلى كل نعمة الله وكل حبه، لكي أحب العمل في المصح، وأن أمارسه برضى وسرور. لأن يسوع صنع مني أنا الذي كنت خاملاً كسولاً، عاملاً يحب أن يبذل نشاطاً. وعمل مني أنا عبد الخمرة رجلاً صبوراً قوياً. وجعل مني أنا الإنسان عديم الشرف، إنساناً شريفاً. وهذه السجايا التي لم يستطع والداي أن يربياني عليها بالرغم من حبهما لي، والتي لم تستطع الإنسانية أن تحققها لي، بالرغم من قوانينها وضغوطها الهائلة. هذه السجايا طبعني بها يسوع المسيح.
وأنا أعلم الآن من اختباري أنه ما من خطيئة مهما فظعت لا يستطيع يسوع أن يمحوها. ليس فقط لأن الكتاب يقول ذلك، بل لأنني اختبرت هذا الأمر العجيب شخصياً. أنا أعلم أنه يحيا فيّ وأنا فيه. ويقيناً أن السعادة التي يشعر بها ذو القلب الذي نقاه المسيح، لهي سعادة غامرة. وأنا أعزو هذا الامتياز، لتدخل الله في حياتي. وأنا فهمت هذا الامتياز جيداً لكي أعيش بنقاوة قلب.
قال القديس أغسطينوس أن الذين يحبون أن يكونوا روحيين حتى في أجسادهم، يصيرون دون أن يعلموا جسديين حتى في أرواحهم.
هذه لم تكن حالتي لأنني بنعمة الله سلكت الطريق المعاكس، لأن التجاديف التي كنت أتلفظ بها سابقاً ضد الله، خرست في فمي، وحل محلها التسبيح لله والعبادة لذاته. وصرت الآن أذرف دموع الفرح والاعتراف بالفضل، بدلاً من الابتئاس وذلك كلما فكرت في محبة الله المخلصة الواسعة من نحوي.
ب. كويزنيز
إن السلام الذي أتي به المسيح، هو سلام داخلي، أما السلام الخارجي الذي يعطيه العالم، فلا يستطيع أن يدخلنا إلى ملكوت الله. أما الوسيلة التي تتيح هذا الدخول، فهي التوبة. هكذا قال المسيح لنا. إن لم تتوبوا فكذلك جميعاً تهلكون!
وهذه كانت كرازة يوحنا المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله! وأيضاً الرسل الأطهار كرزوا بالتوبة في كل جهات الأرض.
المعروف بالاختبار أنه ليس في وسعي أن أدعو عدواً إلى مائدتي لكي نتعشى معاً بفرح قبل أن أتصالح معه أولاً. هكذا نحن أيضاً أعداء الله بسبب الخطيئة، التي هي التعدي على حق قداسته تعالى. إذن ليست محبتنا البشرية المتروكة هي التي تتيح لنا الدخول إلى ملكوت الله. بل ندخل بالمصالحة مع الله بيسوع المسيح، الذي دفع ثمن المصالحة بموته الفدائي. كما هو مكتوب: «وَلٰكِنَّ ٱلْكُلَّ مِنَ ٱللّٰهِ، ٱلَّذِي صَالَحَنَا لِنَفْسِهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ، وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَالَحَةِ، أَيْ إِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ فِي ٱلْمَسِيحِ مُصَالِحاً ٱلْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ» (2 كورنثوس 5: 18 و19).
كل طريقة أخرى للمصالحة مع الله، والدخول إلى ملكوته وهم، يمكن به أن نضل أنفسنا، ونخدع الآخرين. ولكن ليس في وسع أحد أن يخدع الله. المسيح لم يتكلم لنا عن وحدة العالم، بل على العكس يتكلم عن انقسام الناس حول قضيته. قال: «فَإِنِّي جِئْتُ لأُفَرِّقَ ٱلإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ، وَٱلٱبْنَةَ ضِدَّ أُمِّهَا، وَٱلْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا» (متى 10: 35).
وأيضاً لم يخبرنا عن وحدة أبناء البشر فيما بينهم، بل كلمنا عن انقسامهم، إذ قال: «لأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ ٱلآنَ خَمْسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ: ثَلاَثَةٌ عَلَى ٱثْنَيْنِ وَٱثْنَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ» (لوقا 12: 52).
والمعروف بالاختبار أن الأتقياء الزائفين لا يتعمقون في كلمة الله، ولا يعيشون بموجبها وفقاً لدعوة المسيح التي تبدأ بنكران الذات.
لذلك فالكرازة بالصليب تحسب جهالة بالنسبة لهم، لأنهم أعداء صليب المسيح (فيلبي 3: 18) ولا عجب في ذلك فقد قال يسوع: «لأَنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَخَبُونَ» (متى 22: 14).
إن كنت أنقل هذه الشهادة للقراء الأحباء، فذلك لكي أؤكد للذين خسروا كل شيء وللذين صارت نفوسهم بلا قوة وبدون رجاء، وللذين لم يبق لهم ما يخسرونه: أنتم في حاجة إلى المسيح اذهبوا إلى المسيح المخلص، فهو الوسيط الوحيد، الذي يجد الهالك عنده الوسيلة الوحيدة لخلاص حياته. اذهبوا إليه وسترون كيف يجعل من حياة ضالة غير نافعة متشائمة، حياة مخلصة للآخرين ومستعدة لكل عمل صالح.
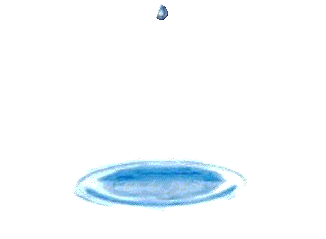




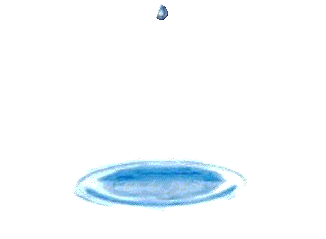 [img][/img]
[img][/img]

